التحول الذي أصاب الدبلوماسية العراقية في عهد البعث كان امتداداً منطقياً لبنية حكم قامت على تسييس الدولة وعسكرة السياسة ولم يكن عرضياً أو اجتهادات فردية. فكما أُخضعت المؤسسات الداخلية لمنطق الولاء الحزبي والأمني، جرى إخضاع السياسة الخارجية بوصفها أداة إضافية في منظومة السيطرة الشاملة على المجتمع وليس باعتبارها مجالاً لإدارة المصالح الوطنية مع الخارج.
كانت وزارة الخارجية قبل ترسّخ الحكم البعثي تضمّ عدداً من الكوادر المهنية التي تلقت تدريبها وفق المعايير الكلاسيكية الرصينة للعمل الدبلوماسي. وقد جرى الاحتفاظ بعدد معقول من السفراء والدبلوماسيين في السنوات الأولى لحكم البعث، ومع تصاعد نفوذ البعث وسطوته واستقواء الأجهزة الأمنية والمخابرات بدأ ذلك التقليد يتآكل تدريجياً. وجرى «تبعيث» الوزارة وفق معيارين: الانتماء الحزبي والقابلية للانضباط والطاعة. وتورد السيدة راقية رؤوف الجلبي قائمة بـ 231 سفيراً جرى تعيينهم بين 1968 و1994 بلغت نسبة البعثيين منهم 80%.
أُقصي في تلك الفترة وما تلاها العديد من الدبلوماسيين ذوي الخبرة أو جرى تهميشهم، واستُبدلوا بعناصر تفتقر إلى التأهيل المهني لكنها تحظى بثقة القيادة السياسية. ومع الوقت، لم يعد السفير ممثلاً للدولة بقدر ما أصبح موظفاً سياسياً، محكوماً بسقف ضيق من الحركة، ومعنياً بنقل خطاب رسمي لا يقبل الاجتهاد. وتقيدت حركة السفير ووصلت الى حد أن يرسل سائق السفير من العراق الى الدولة المضيّفة، وهو يجهل اللغة ولا يعرف العواصم، وواضح بأن مهمته هي التجسس على حركة السفير وعلاقاته (اقرأ مذكرات السفير وهبي القرغولي بعنوان أربعون عاماً في السلك الدبلوماسي العراقي).
ترافق ذلك مع اختزال شبه كامل لعملية صنع القرار الخارجي. فوزارة الخارجية، حتى في عهد طارق عزيز المقرب كثيراً من صدام لم تكن شريكاً في صياغة السياسة، بل منفّذاً لتوجيهات تصدر من أعلى هرم السلطة. وبغياب المؤسسية في إدارة الدولة، تحوّلت السياسة الخارجية إلى سلسلة من ردود الفعل والانفعالات، أكثر منها نتاج حسابات استراتيجية طويلة الأمد. وقد انتشرت في وسائل التواصل مؤخراً وثائق بخط اليد وبتوقيع صدام حسين عن قضايا سياسية كبرى واضح منها أنه كان يتخذ تلك القرارات منفرداً دون استشارة أحد.
هذا الاختزال ألغى عملياً وظيفة الدبلوماسي بوصفه ناقلاً للمعلومة ومقيّماً للمخاطر. فالتقارير التي لا تنسجم مع المزاج السياسي كانت تُهمل أو تُفسَّر باعتبارها ضعفاً في "الروح الوطنية"، وهو ما شجّع على إنتاج تقارير تعكس ما ترغب «القيادة» في سماعه، لا ما يجري فعلاً في العواصم المؤثرة.
وقد تكون تجربة السفير نزار حمدون منفردة كما يتضح من مذكراته التي نشرت مؤخراً، إذ كان أكثر جرأة في التعبير عن رأيه والتنبيه الى مخاطر بعض السياسات بما في ذلك الحرب مع إيران، أو التصعيد ضد الولايات المتحدة أو المسألة الطائفية في العراق. وينطبق الأمر كذلك على برزان التكريتي في جنيف الذي كان يتلقى تعليماته مباشرة من صدام حسين ويدير المفاوضات السرية مع إيران حول الحرب العراقية-الإيرانية حينها. وكلاهما كانا من الدائرة الضيقة للحكم.
بالطبع هناك سفراء محترمون غادروا مناصبهم عندما أتيحت لهم الفرصة رغم ولائهم السياسي البعثي. فمع تزايد أزمات الحكم تحولت السفارات إلى فضاءات ذات وظيفة أمنية وليس مجرّد تمثيل سيادي، وبات من الصعب الفصل بين العمل الدبلوماسي والعمل الاستخباري في أروقة وزارة الخارجية وفي السفارات. ولم يعد السفير، في كثير من الحالات، صاحب القرار الأعلى في بعثته، بل واجهة لعمل أمني يُدار من خارج الأطر الدبلوماسية التقليدية.
كما جرى توظيف الغطاء الدبلوماسي في عمليات تصفية معارضين عراقيين في الخارج، وأحياناً شخصيات كانت في قلب النظام نفسه في عدة عواصم مثل بيروت والكويت ولندن وعدن وغيرها. وقد أفضى ذلك عملياً إلى تشديد الرقابة على البعثات العراقية وتقليص هامش حركتها.
أسهم ذلك المسار في إظهار صورة العراق كدولة تُدار علاقاتها الخارجية بعقلية أمنية مغلقة، وتعتمد سياستها الخارجية على منطق الصدام قبل الدبلوماسية، وتفتقد للقدرة على بناء تحالفات مستدامة، أو على قراءة التحولات الدولية قراءة دقيقة، وتتسع فيها الفجوة بين الخطاب الرسمي والواقع الدولي. وقد ظهر ذلك بوضوح في الثمانينات والتسعينيات حيث أفرغت الدبلوماسية من مضمونها، واستبدلت بمنطق القوة والتهديد، فأصبحت الحروب هي الخيار الوحيد. وقد جرى ما جرى بعد إغفال حصيلة الحرب الباردة والتغيرات التي طرأت على العلاقات الدولية في الربع الأخير من القرن العشرين.
كذلك أدى تداخل الأمن والسياسة الخارجية إلى ضعف التواصل مع الجاليات العراقية في الخارج. وشعرت الجاليات بأن السفارات هي أدوات رقابة ومراقبة أكثر منها دعم وتمثيل سيادي. وأسهمت بيئة الشك تلك في تضييق هامش المبادرة الدبلوماسية. فالمسؤولون في الخارج أصبحوا أقل استعداداً للانخراط في أي حوارات معقدة، وأسرع في الالتزام بالتعليمات الصادرة من بغداد، مهما كانت نتائجها على مصالح الدولة، وبرزت ظاهرة الدبلوماسية الانفعالية على حساب التخطيط الاستراتيجي طويل المدى.
وعندما تصبح السفارات أدوات أمنية تظهر الدولة أكثر انغلاقاً، يسودها الخوف من الداخل أكثر من الرغبة في التفاهم مع الخارج. وقد أسست تلك التوجهات في النهاية لنهج متكامل من العزلة والتوتر، وضع العراق في مواجهة مستمرة مع محيطه الإقليمي والدولي، وصار مسرحاً للأزمات والحروب.















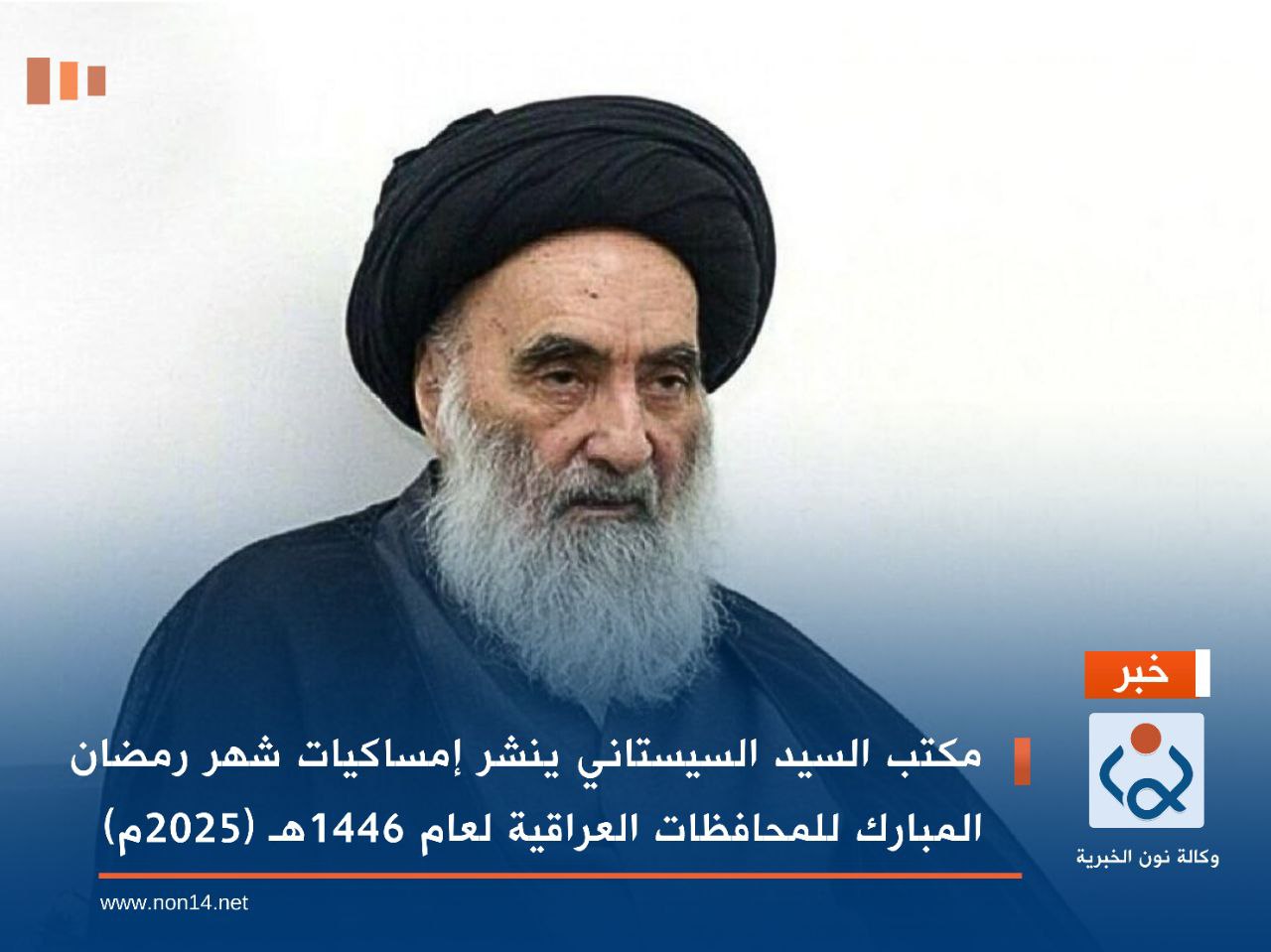




التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!