بقلم: صباح البغدادي
منذ وصوله إلى البيت الأبيض، أثار الرئيس الأميركي “دونالد ترامب”، جدلاً واسعًا بقراراته المفاجئة، أبرزها كان رفع السرية عن ملفات حساسة تتعلق باغتيال شخصيات أميركية بارزة مثل “جون ف. كينيدي ” و”روبرت ف. كينيدي” و”مارتن لوثر كينغ “، وهو ما أعاد إحياء نظريات المؤامرة مرة اخرى بعد ان خفت من حدتها خلال العقد الماضي.
وعلى الرغم من قرار الكونغرس الأمريكي في 1992 برفع السرية عن الوثائق، استمرت الإدارات الرئاسية المتعاقبة في رفض الكشف عنها. وفي الوقت الذي رحب فيه البعض بقرار “ترامب”، طالبت عائلات ضحايا هجمات 11 أيلول سبتمبر بالكشف عن كافة الوثائق السرية المتعلقة بها، وسط تكهنات -ما تزال ترتقي الى المصداقية أن لم يتم نفيها بالوثائق والمستندات الرسميةـ وما نعتقده شخصيا حول تورط جهات أجنبية خارجية ومخابراتية في تهيئة السيناريو لهذه الحدث وتسريبه الى المنفذين (تنظيم القاعدة) بصورة غير مباشرة وعن طريق طرف ثالث ولاننا ببساطة اعتقادنا نابع من تاريخ العمليات السرية الأمريكية خلال الحرب الباردة وذلك عن طريق استخدام حوادث وهمية لتبرير التدخل العسكري ولعلها وأشهرها عملية “نورثوودز” وهي خطة تقوم فيها الحكومة الأمريكية بضرب مصالحها وإلصاق التهمة بكوبا لحشد التأييد الجماهيري لغزو كوبا. وكانت الخطة تحتوي على عدة اقتراحات كخطف أو تفجير طائرات ركاب أو تفجير قواعد عسكرية أمريكية وإلصاق التهمة بكوبا بالاضافة الى وعوده الانتخابية الأخرى بوقف الحرب بين “روسيا/ أوكرانيا” والحرب الابادة التي ما تزال جارية في قطاع غزة؟.
إن الوجه الحقيقي لترامب، ذلك الذي حاول طويلاً إخفاءه خلف ستار الرئاسة يتبين لنا بأنه ليس رجل سياسة، ولا دبلوماسي يتقن أسلوب الحوار، بل تاجر عقارات قاسٍ لا يعرف سوى لغة “معي أو ضدي”. لا منطقة رمادية، لا مناورات دبلوماسية كما يفعل قادة العالم لغرض حل المشاكل التي تواحجههم، بل خط مستقيم يرسمه بقلم الأرباح، حتى لو كان الحبر دماء شعوب أخرى، لكن خطته لتهجير سكان قطاع غزة من أراضيهم التاريخية تكشف وحشيته بلا مواربة. يريد تحويل غزة إلى “ريفيرا” لامعة، لكن أساسات هذا المشروع الشيطاني ستُصب من خرسانة ممزوجة بجماجم وعظام أطفال ونساء وشيوخ، تحللت جثثهم لأكثر من عاميين تحت أنقاض المباني المدمرة، بينما يصرّ على فرض نظريته مهما كانت التضحيات.
في عالم يسعى للسلام، يصر الرئيس “ترامب” على تقديم نفسه كصانع له، لدرجة المطالبة العلنية بجائزة نوبل للسلام، مُستغلاً كل مناسبة لتذكير العالم بما يعتبره “إنجازاته”. لكن الواقع ينقض هذه الادعاءات وينسفها من جذورها، ليظهر فجوة صارخة بين خطاب النصر المزعوم وسياسات التصعيد والدمار على الأرض. وكانت أخرها مساء يوم السبت 20 أيلول 2025، إنه يستحق الفوز بجائزة “نوبل” للسلام تقديرا لجهوده في إنهاء عدد من الحروب.
وفي كلمته بفرجينيا حفل العشاء السنوي الرابع لمؤسسي معهد “أمريكان كورنر ستون”، قال : “عملنا على وقف الحروب بين الهند وباكستان وأرمينيا وأذربيجان وكوسوفو وصربيا وإسرائيل وإيران”. وأضاف: “اعتقدت أن إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا سيكون الأسهل بفضل علاقتي الجيدة بالرئيس بوتين لكن خاب ظني فيه”. وتابع قائلا: “سنحل الموضوع بين روسيا وأوكرانيا بشكل أو بآخر”. وشدد على أنه يستحق أن يحظى “بجائزة نوبل للسلام تقديرا لعملي في إنهاء عدد من الحروب حول العالم , ويدَّعي أنه يستحق الجائزة لجهوده في “إنهاء عدد من الحروب”، لكن الحقائق تقف ضده شاهداً على العكس. فالحرب الروسية الأوكرانية، بدلاً من أن تهدأ، تتجه نحو التصعيد بشكل غير مسبوق، مع رفع وتيرة التسليح وغياب أي خطة دبلوماسية حقيقية لوقف إراقة الدماء. بدلاً من دفع الأطراف نحو طاولة المفاوضات، نرى خطاباً يؤجج النزاع ويمدده.
المثال الأكثر فظاعة يكمن في التعامل مع الحرب على قطاع غزة. بينما كان بإمكان الرئيس السابق بايدن استخدام ورقة ضغط حقيقية بوقف شحنات السلاح لإسرائيل لدفعها نحو وقف إطلاق النار، فإن سياسة ترامب جاءت كارثية: دعم عسكري مطلق وغير مشروط، ورفض أي دعوة لوقف إطلاق النار في مجلس الأمن، وخطاب يحث على التصعيد و”الحل” عبر القوة فقط، متجاهلاً آلاف الضحايا من الأطفال والنساء والمدنيين والدمار الكامل الذي حل بالقطاع. حتى الحلقة المفترضة للتفاوض حول تبادل الأسرى تحولت إلى مطلب أحادي: “إطلاق الرهائن دون أي شروط”، وهو موقف متصلب يقتل أي أمل في عملية سياسية.
وليست غزة وحدها. فالقصف الذي استهدف الدوحة، والذي تشير معلومات مسربة إلى موافقة ترامب الضمنية عليه، يمثل صفعة لكل القواعد الدبلوماسية والأعراف الدولية. إنه إعلان بأن سياسة “العصا الغليظة” هي منهج إدارة ترامب، لا مكان فيها للحوار أو لحرمة السيادات أو لحل النزاعات بالوسائل السلمية. أي سلام يمكن أن ينبثق من تحت أنقاض السفارات والعلاقات الدولية المهدرة؟
حتى الادعاء بوقف الحرب بين الهند وباكستان يتهاوى عند التدقيق. فما حدث لم يكن “صناعة سلام” بقدر ما كان مغامرة عسكرية فاشلة، حاولت فيها الإدارة استنساخ نموذج الضربات الإسرائيلية لسوريا أو إيران. لكن الخطة انقلبت عندما أظهرت باكستان قدرة على رد غير متوقع، مما أجبر الهند على التراجع خوفاً من التصعيد غير المحسوب. لقد أوقفَتْها حسابات الخسارة والمكسب العسكري، وليس براعة دبلوماسية أو رغبة في السلام. أن توقف حرباً كادت أن تشتعل بسبب مغامرتك، ثم تطلب عليها جائزة، (هذه) قمة السخرية.
وما بدأ مجرد ادعاءات متكررة تحول في ولاية ترامب الثانية إلى قناعة راسخة، بل إلى “حق مكتسب” في نظره. لقد تجاوز الأمر مجرد رغبة أو أمنية إلى حالة من “جنون العظمة المؤسسي”، حيث أصبح الرئيس مقتنعاً ليس فقط بأهليته للجائزة، بل بأنها ستكون من حصته الشخصية هذا العام، وأن أي مساس بهذا “الحق” هو إهانة شخصية وسياسية له وأنصاره.
هذه القناعة ليست بريئة، بل ستترجم إلى “استراتيجية هجومية منسقة” تقودها ماكينة ترامب السياسية والإعلامية. لن يقف أنصاره مكتوفي الأيدي، بل نحن نعتقد وقد نكون على ثقة مطلقة وتامة غير قابلة للتأويل أو الشك بانهم سيشنون حرباً على ثلاثة جبهات رئيسية:
1. حملات التضليل والإلحاح: ستُطلق حملات منهجية على منصات التواصل الاجتماعي تروج “إنجازات ترامب للسلام” المزعومة – من التطبيع بين بعض الدول العربية وإسرائيل الذي تجاوزته الحرب على غزة، إلى ادعاء منع حروب مستقبلية – بهدف خلق ضغط شعبي مصطنع ورواية بديلة تغذيها آلة إعلامية جبارة، محاولة التأثير على لجنة نوبل النرويجية عبر الرأي العام.
2. حملات التشويه الانتقامية: إذا فشلت عملية الضغط، وإذا تجرأت اللجنة ومنحت الجائزة لشخصية أخرى تكرس نفسها للسلام الحقيقي (الدبلوماسيين العاملين على وقف إطلاق النار أو المدافعين عن حقوق الإنسان)، فإن رد الفعل لن يكون مجرد خيبة أمل. ستتحول الآلة إلى وضع الهجوم. سيتم تشريح تاريخ اللجنة، والبحث عن أي ثغرة أو قرار مثير للجدل في الماضي لتشويه مصداقيتها بالكامل. الرسالة ستكون واضحة: “إما أن تمنحي الجائزة للرئيس، أو سندمر سمعتك”.
3. التصعيد إلى مستوى العقوبات الرسمية: هذا هو البعد الاستراتيجي الخطير. لا يتوقف الأمر عند التشويه الإعلامي. فبما أن لجنة نوبل النرويجية هي هيئة نرويجية (وليست دولية بالكامل)، فإن ترامب قد يرى في قرارها إهانة للولايات المتحدة. استناداً إلى سابقة هجومه على مؤسسات الأمم المتحدة الحقوقية ومحكمة الجنايات الدولية، وليس مستبعداً أن يفرض عقوبات على أعضاء اللجنة. قد تتخذ هذه العقوبات شكل تجميد أصولهم أو منعهم من دخول الولايات المتحدة، في خطوة غير مسبوقة ستُسَيِّس الجائزة بشكل كامل وتجعل منها ساحة للصراع والانتقام.
بهذه الإستراتيجية، لم تعد جائزة نوبل للسلام مجرد وسام شرف، بل تحولت في عقلية ترامب وأنصاره إلى “غنيمة حرب سياسية” يجب انتزاعها بأي ثمن. إنها جزء من الحرب الثقافية الأوسع التي يخوضها، حيث يتم تحطيم هيئات المجتمع الدولي والنخب التقليدية إذا رفضت الخضوع لمشيئته وإرادته. المشهد لم يعد يدور حول استحقاق السلام من عدمه، بل حول اختبار قوة الإرادة الأمريكية الجديدة تحت قيادة ترامب ضد ما يراه “نظاماً عالمياً فاسداً”. الفائز في هذه المعركة لن يكون السلام، بل ستكون القوة الغاشمة والتلويح بها، مما سيدمر أي معنى متبقي لأشهر جائزة سلام في العالم.
جائزة نوبل للسلام تُمنح لصناع السلام الحقيقيين، لأولئك الذين يخاطرون من أجل وقف نزيف الدماء، ويبذلون الجهد في بناء جسور التفاهم، ويدفعون نحو العدالة كأساس لأي سلام دائم. ما يقدمه ترامب هو نقيض ذلك تماماً: خطاب تصعيدي، ودعم غير محدود للحروب، وتقويض للمؤسسات الدولية، ومغامرات تهدد الاستقرار العالمي.
إن الإصرار على المطالبة بنوبل السلام في خضم هذا السجل ليس سوى محاولة يائسة لطلاء صورة الواقع الدموي بأوهام العظمة، وهو استهانة بذكاء العالم وذاكرة الضحايا. التاريخ لن يتذكر ترامب كصانع للسلام، بل كقائد فتح مختبرات السلاح وأغلق أبواب الدبلوماسية، وفضل لغة القوة الوحشة على لغة الحوار والحل. فليحتفظ بأوهامه، وليترك للعالم مهمة البحث عن السلام الحقيقي بعيداً عن نرجسيته الخطيرة وأوهام جنون العظمة.













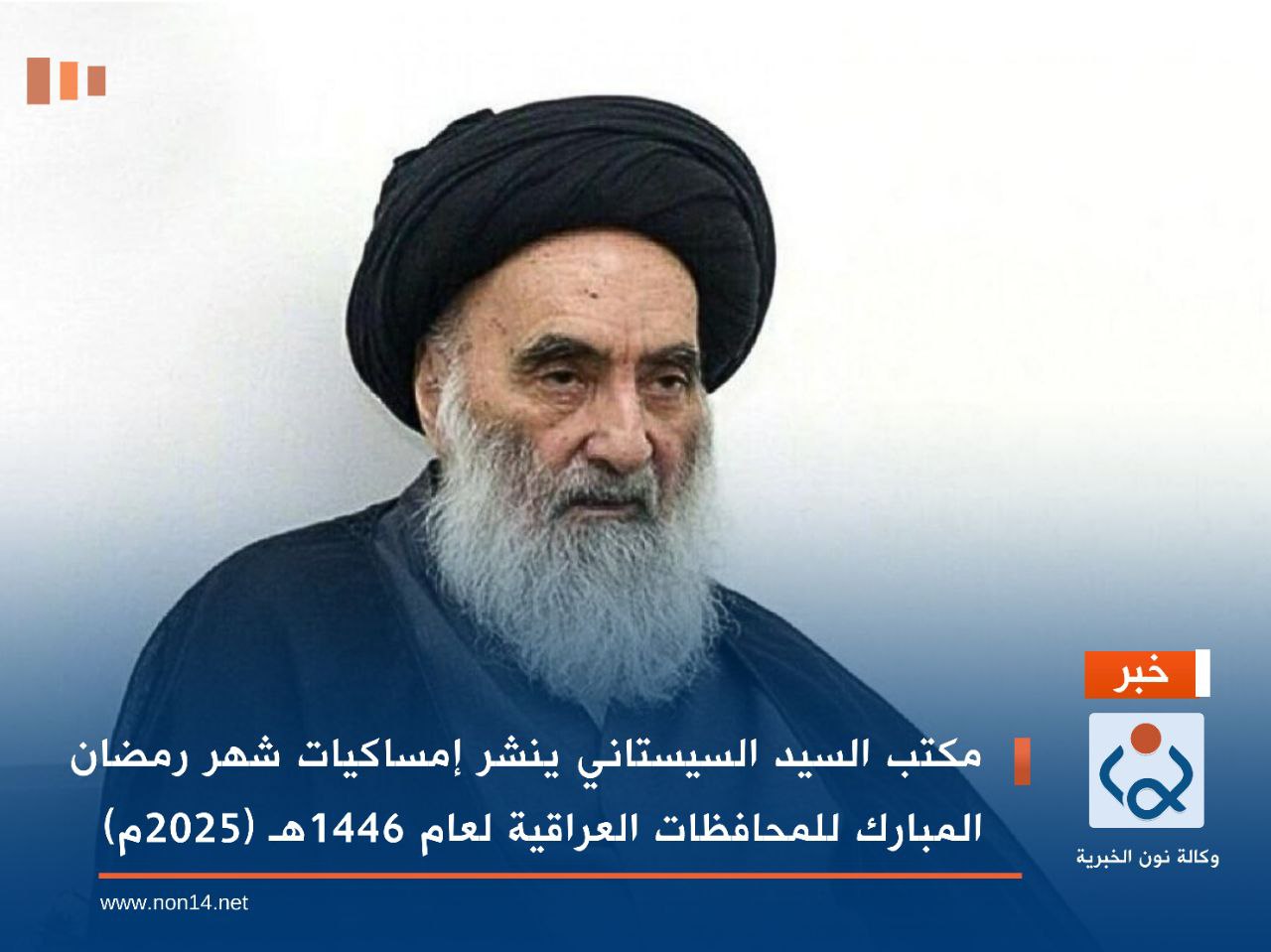




التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!