لا ظل من ريب في تلك الرغبة الأكيدة والقوية لدى الأسر داخل المجتمعات الواعية، في إلحاق أبنائهم بالعملية التعليمية، اقتناعًا وإدراكًا بأنها الجانب الموازي للتنشئة الأسرية في بناء شخصية الإنسان. ومن هنا، نفهم هذا الحرص الكبيرَ لدى الآباء في تعليم أبنائهم، وإتاحة الفرصة لهم في هذا الحقل الحياتي الضروري للإنسانية جمعاء، حتى وإن تجاوز الأبناء آباءهم في تلك الفرص والتحقوا بأكبر وأعلى المستويات. ذلك أن التعليم -باعتباره الركيزة التي تُبنى عليها حضارات الأمم وأمجادها وتستشرف به مستقبلها وترتقي بها المجتمعات- يمثل حقًا من الحقوق الأساسية التي كرّستها التشريعات الوطنية ونصت عليها المواثيق الدولية.
غير أن هذا الحق لا تتوفر له الصورة المكتملة والمثلى بمجرد توفير الأبنية اللائقة فحسب، سواء من مدرسة أو فصل دراسي، بل إنه يرتبط وثيقًا بتوفير عوامل أخرى تتوازى تمامًا أو تتقدم البناء. وهذه العوامل يأتي في مقدمتها وجود بيئة آمنة، يشعر فيها التلميذ والطالب والطفل بأنه محاط بجدار من الأمان والحماية، أهم وأكبر وأكثر احتواء من الجدارات الأسمنتية، بحيث تنقشع عن نفسه الرهبة من عالم المدرسة، ويشعر بثقة مبنية على الطمأنينة تدفعه بلطف وحماس معًا إلى الإقبال على التلقي والتحصيل والاستذكار، والحرص على ألا يغيب يومًا حتى لا تضيع عليه فرصة لقاء مُعلِم ومعلمة رأى فيهما أبويه، وحتى لا تكون هناك فجوة علمية تؤثر على مساره التعليمي.
وقد عُنيت اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها تقريبًا جميع دول العالم، حيث تُعد أهم وثيقة دولية أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٨٩، لتدخل حيّز التنفيذ عام ١٩٩٠، بحماية حقوق الأطفال في العالم.
ونصت المادة ٢٨ من الاتفاقية على حق الطفل في التعليم، وإلزام الدول باتخاذ التدابير اللازمة لضمان انتظام الحضور في المدارس وتقليل معدلات التسرب. هذه التدابير قطعًا تشتمل على توفير وضمان الأمان والحماية التامة التي تُشعر التلميذ/الطفل بأن المدرسة ليست مجرد مكان لتلقي المعرفة، لكنها في مقام آخر امتداد لمنزله الآمن، وأنها الفضاء الاجتماعي الهادئ والضروري لبناء نفسه، وصناعة شخصيته ومستقبله، تُصقل فيه موهبته وتُغرس فيه مزيدٌ من القيم بروحه وينمو فيه إبداعه، وينطلق عقله إلى الحدود الأرحب من التفكير. ولن يتأتى كل ذلك إلا باعتبار ووصف الأمان المدرسي شرطًا للتعليم الجيد، وعنصرًا أساسيًا لا ينفصل عن جودة النظام التعليمي المتعلق بالمواد الدراسية والكتب وطرق الشرح والامتحانات وغيرها.
وفي الفترة الأخيرة، يشهد بعض قليل من المدارس حوادث غير مألوفة من شأنها تهديد هذا الشعور بالأمان، ولفت الانتباه إلى ثغرات في المنظومة الإدارية والتعليمية والتربوية في تلك المدارس، ناتج معظمها عن غياب الإعداد القويم للقائمين على العملية التعليمية، وتداخل الأدوار وسوء الإدارة. وفجوات أخرى تأتي انعكاسًا لتحولات اجتماعية أوسع تتداخل فيها التغيرات السلوكية مع التكنولوجيا واستخداماتها، والثقافات المشوهة التي تؤثر على نفسية النشء، ويكون منبعها تلك النوافذ الإلكترونية التي تتزايد يومًا بعد آخر.
فينتج عن كل ما تقدم حوادث العنف الجسدي أو اللفظي، سواء بين الطلاب أنفسهم أو بين طالب ومعلم، وقد يزداد هذا النوع من الحوادث عند غياب سياسات واضحة للتعامل مع السلوكيات العدوانية، أو في حالة ضعف الإشراف داخل المدرسة، أو وجود إشراف شكلي لا يقدم أو يؤخر، مع غياب المتابعة لتحرك الطلاب وكل فرد داخل السور المدرسي.
ففضلًا عن الإصابات التي تنتج عن سوء التجهيزات مثلًا ك انهيار جزئي أو تزاحم على الدرج بين الفصول العلوية، تبرز مشكلات نوعية أخرى تتعلق بالسلوك الفردي الذي يصل إلى التعدي بأي صورةٍ من الصور، أخطرها التعدي على الطلاب سواء من طلاب مثلهم أو عناصر أخرى: معلمين وعاملين وسُعاة وما إلى ذلك. ومن المؤسف أن يحتمل هذا التعدي كل الأنواع حتى التي لا يمكن تصورها. ومن ثم، يُتوقع هذا الأثر النفسي والاجتماعي للحوادث على الطلاب الأطفال، والذين نعدهم لبنة أولى وأساس بناء الأمم.
وبلا حصر، يتأثر الطفل الذي يعيش تجربة الخوف نفسيًا تأثرًا قد يصل إلى المرض العُضال، وتتأثر قدرته على التركيز والتحصيل، ويُصاب بحالة من القلق والترقب، وطبيعي أن يتطور الأمر إلى رفض الذهاب إلى المدرسة، وفقدان الثقة في المعلمين بل وفي بعض الأشخاص المحيطين، وتكون لديه دوافع وهمية بما يتصوره حماية نفسه، أي تظهر عليه الاضطرابات السلوكية، ويصاب بانعدام ثقة مطلق في أي عالم خارجي، بما أن المدرسة هي النموذج الأوضح لهذا العالم.
وأمام هذه الظواهر التي يمكن وصفها بالفردية، غير أنها تفتح أبواب المخاطر في وجه المجتمع على مصراعيها، فينبغي أولًا لجميع الأطراف المرتبطين بالمجال التعليمي، من أولياء الأمور وصولًا لكل عامل ومدرس ومسئول، فهم أن المدرسة ليست فضاء محايدًا، ولكن هي بالأساس بيئة يتعامل فيها الطفل مع العالم الخارجي خارج دائرة الأسرة، وأن ما يتعرض له فيها يبقى محفورًا في ذاكرته لسنوات طويلة. والعمل وفق ذلك على اتخاذ جميع التدابير الواجبة لتحقيق أمان كل طفل يتعلم، في عمل تتحقق فيه معادلة المنظومة التي تضم الأهالي، ووزارة التربية والتعليم، والإدارة المدرسية، والمعلمين، وحتى الطلاب أنفسهم، والاتفاق الضامن على بناء نموذج فعال للأمان عبر تجهيز البنى الأساسية وفق معايير السلامة، ووضع لوائح مُلزمة ومفهومة للسلوك والالتزام، وإعلان سياسات مكافحة التعدي والعنف والتحرش والتنمر بوضوح، مع تطبيقها بشكل صارم، ووجود آليات ضامنة للإبلاغ عن أي انتهاك لأي معايير، وتدريب الكوادر التعليمية على اكتساب ميزات الاحتواء والطمأنينة والدفع والتشجيع، والتعامل مع السلوكيات الصعبة، والإسعافات الأولية. لا أن يكون المعلم مجرد ناقل أو شارح، بل هو قائد الأمن النفسي الأول للطلاب. وتعزيز دور الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، والشراكة المستمرة مع الأسرة. وبالنسبة للأسرة والمدرسة معًا، يجب مراقبة استخدام الهواتف، وتنظيم المحتوى الرقمي، وتوعية الطلاب بمخاطر التنمر الإلكتروني، وجميع أنواع المخاطر التي يُبقيها الاستخدام الإلكتروني الخاطئ وغير الرشيد.
وعلينا جميعًا أن نعلم ونوقن ونعمل بما علمنا من أجل أبنائنا، أن تشييد مدرسة آمنة يعني الوصول بالبناء إلى جوهر النظام التعليمي القوي، وأن المدرسة ليست مكانًا لصناعة المتعلمين، لكنها بالأساس مكان وزمان لصياغة أفراد في المجتمع قادرين على بناء الأوطان، وإدراك أن الطفل الذي يشعر بالأمان بالضرورة سوف يطرح الأسئلة، ويسعى للتعلم، ويتعلم ويبدع، ويثق بنفسه وبمؤسسته، فينطلق حرًا قويًا محلقًا محبًا لوطنه وعازمًا على بنائه ببصمة في عقله وروحه.













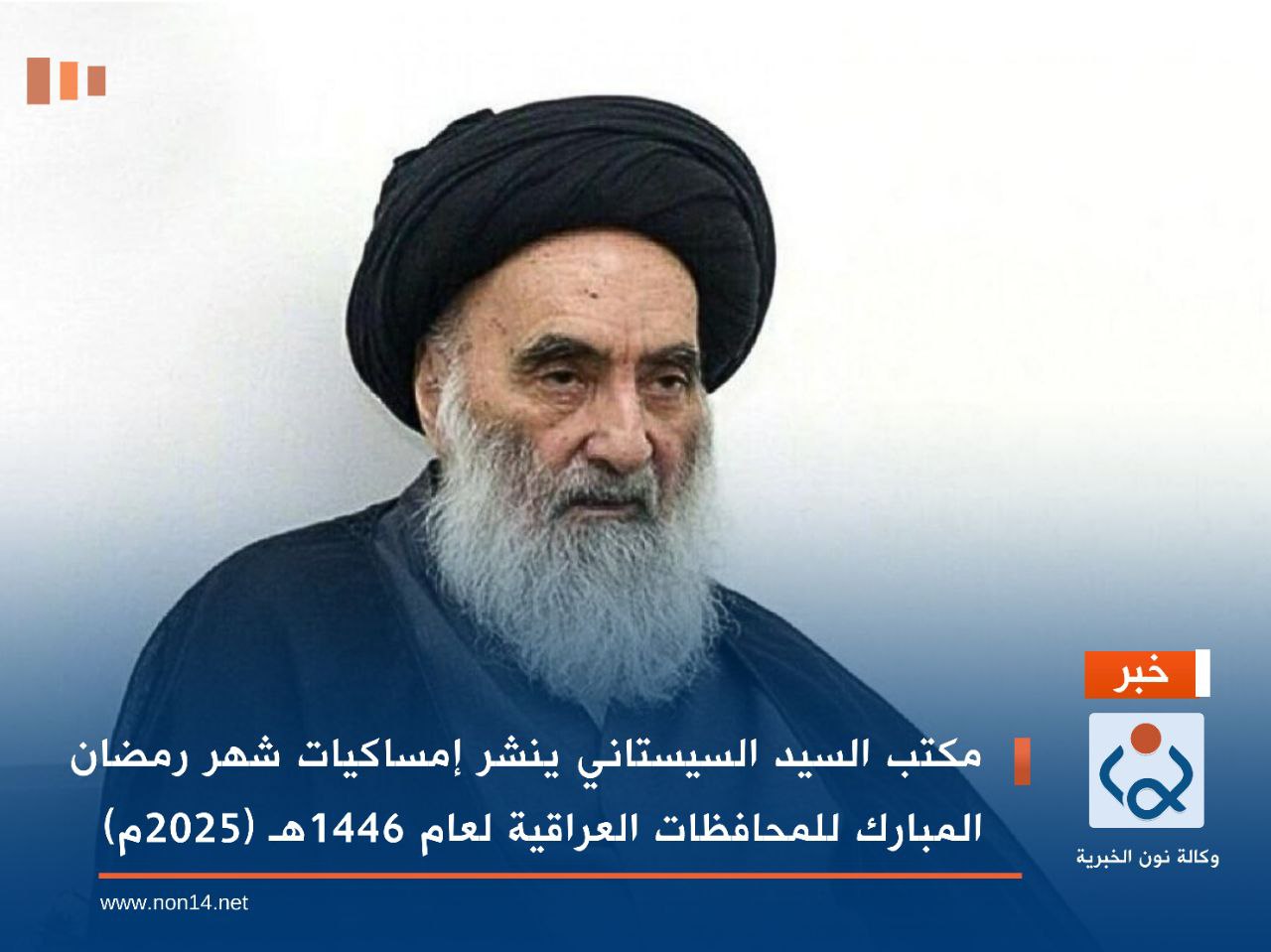




التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!