بقلم: كريم محسن
في واحدة من أشهر لقطات المسرح العربي وقف عادل إمام، أمام القاضي في مسرحية “شاهد ما شافش حاجة” وهو يروي قصة عن واحد في آخر نفق العباسية يبيع عصير قصب فيسأله القاضي (وما له) فيرد عادل إمام (وحش.. لا تشرب منه) فيضحك الجمهور بينما يكتشف صاحب محل العصير الذي كان ينوي رفع دعوى أمام القضاء على المسرحية، أن هذه النكتة رفعت من عدد زبائنه الذين وفدوا اليه من مصر ومن خارج مصر لتناول العصر.. بدلا من أن تسيء إليه ففتح فرعا ثانيا وثالثا وصار يستفيد من السخرية التي كان يظنها إساءة؛ اليوم يمكن أن نعيد إنتاج هذه الحكاية في عصر مختلف تماما عصر تتحول فيه السخرية والتفاهة إلى صناعة مربحة وصانعيها إلى مشاهير على حساب وعي الناس وثقافتهم إذ صار كثير من الأشخاص الذين لا يمتلكون أي موهبة حقيقية أو معرفة نافعة يطلون علينا في وسائل التواصل الاجتماعي ليصنعوا مشاهد مضحكة أو ساذجة أو صادمة وكلما ازدادت سخافتهم ازداد عدد المتابعين والمشاهدات وزادت الأرباح وهنا تكمن المفارقة الكبيرة التي تجعلنا أمام واقع جديد خطير لا يشبه شيئا مما عرفته الأجيال السابقة.
قبل عقود لم يكن المواطن العادي يعرف الشهرة إلا عبر التلفاز أو الراديو أو الصحف وكان الطريق إلى النجومية يحتاج إلى جهد ودراسة وموهبة وصبر فالممثل لا يظهر على الشاشة قبل أن يتدرب في المسرح أو يثبت نفسه في أدوار صغيرة والكاتب لا ينشر كتابه قبل أن يراجع ويمحص ويمر بفلترة طويلة أما اليوم فقد أصبح الهاتف الذكي هو المسرح والمايكروفون والكاميرا ودار النشر ومنصة التوزيع في آن واحد وصار أي شخص يمتلك اتصالا بالإنترنت قادرا على بث ما يشاء في لحظة ومن دون أي معايير والنتيجة أن الساحة امتلأت بأصوات ضجيج وصور بلا معنى وتفاهات تغزو العقول بلا رقيب.
أسباب هذه الظاهرة متعددة أولها أن الإنسان بطبيعته ينجذب إلى المثير والمختلف حتى لو كان سخيفا فهو يضحك أو يدهش أو يثير فضولا عابرا فيضغط على زر المشاهدة ويشارك المقطع مع أصدقائه ومن ثم تتسع الدائرة مثل كرة الثلج ثانيها أن المنصات الرقمية نفسها مبنية على خوارزميات تبحث عن التفاعل لا عن القيمة فما دمت تحصد الإعجابات والمشاركات فأنت رابح عندها حتى لو كان المحتوى الذي تقدمه مضرا أو فارغا ثالثها أن جزءا كبيرا من المجتمعات العربية يعاني فراغا ثقافيا وضعفا في مؤسسات التربية والتعليم ما يجعل الشباب والأطفال أكثر عرضة للتأثر بما يلمع أمامهم من صور ونجوم مزيفين رابعها أن هناك أزمة ثقة عميقة بين الجمهور وبين المؤسسات الثقافية والفكرية الرسمية أو الأحزاب السياسية أو الإعلام التقليدي مما يدفع الناس إلى الهروب نحو منصات تتيح لهم محتوى سهل الهضم سريع ومجاني حتى لو كان ضارا.
انتشار هذه الظاهرة ليس بلا ثمن فالمتابعة المستمرة للمحتوى التافه تعيد تشكيل الذوق العام وتدرب الأجيال الجديدة على أن الشهرة يمكن أن تتحقق بلا علم ولا موهبة وأن الربح يمكن أن يأتي من التهريج بدلا من العمل والإبداع وهذا أخطر ما يمكن أن نتركه لأطفالنا الذين يكبرون وهم يعتقدون أن صناعة المستقبل لا تحتاج إلا إلى هاتف وكاميرا وحركات هزلية كما أن هذا النوع من المحتوى يرسخ قيما سلبية مثل السخرية من الآخرين والبحث عن الضحك على حساب الكرامة والاستهانة بالعلم والمعرفة واعتبار الجهل مادة للتسلية في حين أن المجتمع الذي يحتفي بالجهل لا يمكن أن يبني حضارة ولا اقتصادا ولا سياسة راشدة.
الأضرار النفسية أيضا كبيرة فالمراهق الذي يقضي ساعات يومه أمام فيديوهات لا تقدم سوى صراخ ومقالب وعبارات مبتذلة يفقد تدريجيا قدرته على التركيز وعلى التعامل مع القضايا الجادة ويصبح أسير البحث عن المتعة السريعة كما أن هذا الاستهلاك المستمر للمحتوى الفارغ يضعف اللغة ويقزم الخيال ويجعل الهوية الثقافية ممزقة بين تقليد سخافات الآخر وبين فقدان العلاقة مع التراث والمعرفة الرصينة وفي النهاية نصل إلى ما يشبه عصر التفاهة حيث تتحول المنصات إلى أسواق مفتوحة للضجيج والهراء.
إذا أردنا أن نواجه هذه الظاهرة فلا يكفي أن نشتمها أو نلعنها بل علينا أن نفكر في حلول عملية تبدأ من الأسرة فالبيت هو المدرسة الأولى وعلى الآباء والأمهات أن ينتبهوا إلى ما يشاهده أبناؤهم وأن يضعوا حدودا زمنية للمحتوى وأن يقدموا لهم بدائل نافعة مثل الكتب والألعاب التعليمية والأنشطة الرياضية والفنية ومن هنا أيضا تظهر أهمية استعادة دور الجد والجدة داخل الأسرة ذلك الدور الذي كان يمارس بصورة غير مباشرة لكنه عميق الأثر فقد كانوا يحكون القصص الشعبية والحكايات التاريخية التي تنمي خيال الأطفال وترسخ فيهم قيم الشرف والعفاف وتغرس بداخلهم احترام الكرامة وتجنب الأخطاء مثل الكذب والسرقة وتشجعهم على طاعة المعلم والمعلمة وتبين لهم أن التعليم هو الطريق ليكونوا رجالا ونساء ذوي قيمة في بناء الوطن وحمايته من التحديات الخارجية والداخلية هذا الدور التربوي الذي كان طبيعيا وبسيطا صار اليوم ضرورة ملحة في زمن يقتحم فيه الهاتف عقول الصغار قبل أن تكتمل شخصياتهم.
ثم يأتي دور المدرسة التي ينبغي أن تربي على التفكير النقدي وتعلم الأطفال كيف يميزون بين المحتوى الهادف والمحتوى الفارغ وكيف يقيمون ما يرونه بعيون ناقدة لا بعيون مبهورة ثم هناك مسؤولية الإعلام التقليدي الذي يمكن أن يستعيد جزءا من جمهوره لو قدم محتوى عصريا جذابا لا يخلو من قيمة ومعرفة ثم تأتي مسؤولية الدولة في سن قوانين تشجع المحتوى المفيد وتحد من التافه دون أن تسقط في فخ الرقابة القمعية وأخيرا هناك مسؤولية المجتمع المدني والنخب الثقافية في أن تبتكر طرقا لمنافسة هذه الموجة عبر محتوى شبابي ذكي يدمج بين المتعة والفائدة.
الناس قبل عصر الميديا كانوا يجلسون في المقاهي ليستمعوا إلى شاعر أو يحكون لبعضهم القصص والأمثال وكانت الأجيال تنمو على ذاكرة جماعية تصنعها الحكاية الشعبية والأغنية الوطنية والمقالة الفكرية وحتى النكتة كانت لها وظيفة اجتماعية تفرغ الاحتقان أو تنتقد السلطة أما اليوم فقد صار كل ذلك يذوب في بحر من المقاطع المكررة التي لا تحمل أي سياق أو قيمة ومع أن التكنولوجيا منحتنا إمكانات هائلة للتواصل إلا أن سوء استخدامها جعلنا نعيش فوضى معرفية تتساوى فيها الكلمة العميقة مع العبارة السوقية ويتساوى فيها الجهد الإبداعي مع التفاهة المصنوعة.
من هنا يمكن القول إن أخطر ما يهدد مجتمعاتنا ليس فقط البطالة أو الفقر أو الفساد بل أيضا هذا الانحدار الثقافي الذي يغزو بيوتنا عبر الشاشات الصغيرة إننا نصنع بأيدينا جيلا يستهلك ولا ينتج ويضحك ولا يفكر ويتابع ولا يشارك في البناء وإذا لم ننتبه فقد نجد أنفسنا بعد سنوات أمام مجتمع كامل يعيش في فراغ معرفي وروحي ويكتفي بأن يردد ما يسمعه من نجوم زائفين صنعناهم نحن بمتابعتنا وإعجاباتنا ومشاركاتنا.














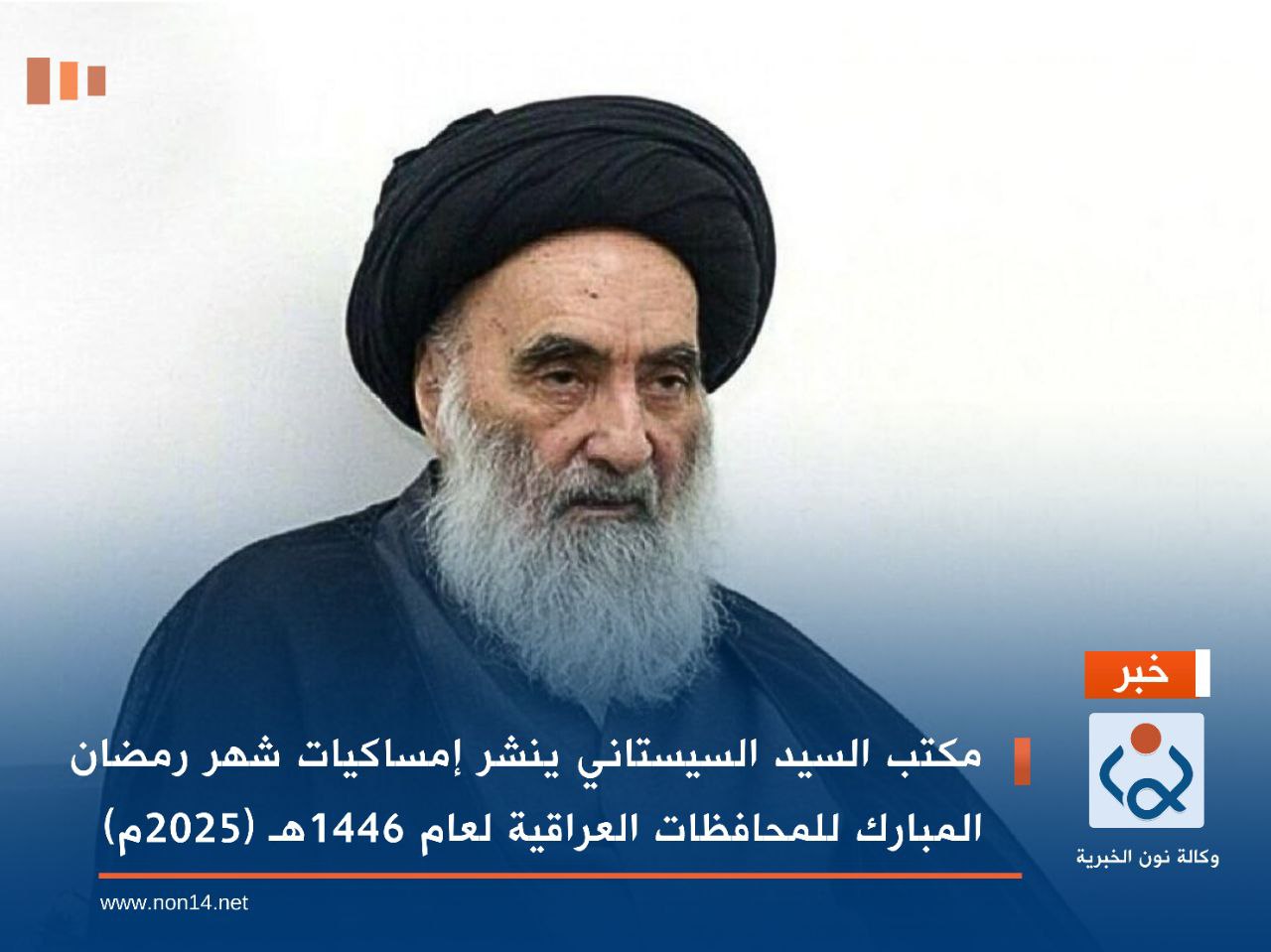




التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!