بينما كنت أجلس أمام شاشة التلفاز أتابع تدفق الأخبار المتسارع، وما يحمله من ضجيج العالم وصراعاته، كانت ابنتي – تلميذة الصف الرابع الاعدادي – تجلس بجانبي والهدوء يلفها، غارقة بين أوراقها وكتبها تحضيرا لامتحانات نصف العام في مادة التربية الإسلامية.
وسط هذا التباين بين قلقي من الأخبار وانهماك ابنتي في المراجعة، استوقفني صوتها وهي تردد بتركيزٍ عال حديثا شريفا للنبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. لم يكن مجرد نص تحفظه لتجتاز به الامتحان، بل كان نداء أيقظ في نفسي تساؤلات عميقة لم تخطر ببالي منذ زمن.
لقد جعلني ذلك الموقف، وتلك الكلمات النبوية تحديدا، أتوقف عن متابعة “العالم الخارجي” لأغوص في “عالمنا الداخلي”، وأعيد التفكير في الكثير من المفاهيم التي نغفل عنها في زحام الحياة. وفي السطور التالية، سأتطرق لهذا الحديث الذي أعاد ترتيب أفكاري في لحظة عفوية جدا.
أزمة اقتصادية تتجاوز الظرف الآني
في خضم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها المجتمع العراقي اليوم، تتعاظم التحديات المعيشية وتزداد الضغوط على المواطن، لا سيما بعد قرارات المجلس الاقتصادي المتعلقة باستقطاع مخصصات الشهادات العليا، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار، واضطراب سعر صرف الدولار، وتراجع القدرة الشرائية. هذه التطورات ليست مجرد أزمة عابرة، بل هي نتيجة تراكمات طويلة في بنية الاقتصاد العراقي، كشفت هشاشته واعتماده شبه الكلي على مورد واحد.
الاقتصاد الريعي.. أصل المشكلة
يصنف العراق ضمن الدول ذات الاقتصاد الريعي، أي الاقتصاد الذي يعتمد اعتمادا شبه كامل على إيرادات النفط، دون تنويع حقيقي في مصادر الدخل. وعلى مدى أكثر من عشرين عاما، بقي النفط هو العمود الفقري للموازنة العامة، في مقابل ضعف القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة والتجارة.
هذا الاعتماد جعل الدولة رهينة لتقلبات أسعار النفط، فأي انخفاض أو أزمة عالمية تنعكس مباشرة على الرواتب، والمخصصات، والمشاريع، والخدمات، وهو ما يفسّر تكرار الأزمات المالية التي يعيشها البلد.
ثقافة الوظيفة الحكومية وتضخم الجهاز الإداري
من أبرز ملامح الأزمة الاقتصادية في العراق هو الإقبال الكبير على الوظيفة الحكومية، التي تحولت في الوعي الجمعي إلى رمز للأمان والاستقرار، بل إلى غاية يسعى إليها الجميع. وعلى مدى سنوات، تصاعدت المطالبات بالتعيين دون النظر إلى قدرة الدولة أو حاجة السوق، ما أدى إلى تضخم الجهاز الوظيفي بشكل يفوق الإمكانات المالية.
هذا التضخم لم يخلق إنتاجا حقيقيا، بل زاد من الأعباء على الموازنة العامة، وأضعف قدرة الدولة على الاستثمار والتنمية، وكرس حالة من البطالة المقنعة، حيث يتحول الراتب إلى هدف بحد ذاته، لا إلى أداة إنتاج.
لماذا الإعراض عن العمل الحر؟
يثير هذا الواقع سؤالا جوهريا: لماذا هذا الإصرار على الوظيفة مقابل العزوف عن العمل الحر والتجارة والصناعة؟
الجواب لا يرتبط فقط بالاقتصاد، بل بثقافة اجتماعية ترسخت عبر سنوات، جعلت العمل الحكومي أعلى شأنا من العمل الخاص، رغم أن التجارب العالمية تثبت أن الاقتصادات القوية تبنى على المبادرات الفردية، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والإنتاج الحقيقي.
النداء الخفي الذي سمعته من ابنتي
اللافت أن ثقافة العمل الحر ليست دخيلة على مجتمعنا، بل هي متجذرة في تراثنا الديني. فقد قال النبي محمد ﷺ: «ما أكل أحد طعامًا قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده». وهذا الحديث يؤكد أن أفضل الكسب هو ما كان قائمًا على الجهد الشخصي والإنتاج، لا الاتكال.
كان النبي داود عليه السلام نموذجا فريدا في الجمع بين السلطة والنبوة والعمل اليدوي، وقصته تعد أعظم دليل تاريخي وديني على أهمية “الصناعة” كحرفة ترفع من شأن الفرد وتغنيه عن السؤال.
اشتهر النبي داود بصناعة الدروع الحربية (الزرد)، وقد ذكر القرآن الكريم ذلك صراحة في قوله تعالى:《وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ ۖ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكرُونَ》 (الأنبياء: 80).
قبل النبي داود، كانت الدروع تصنع من صفائح معدنية ثقيلة تعيق حركة المقاتل. لكنه ابتكر “الدرع المسرود” المكون من حلقات حديدية متشابكة، تجمع بين القوة والمرونة وسهولة الحركة. وجهه الله سبحانه وتعالى إلى إتقان الصنعة في قوله:《أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ》 (سبأ: 11)، والسرد هو نسج حلقات الدرع بدقة بحيث لا تكون واسعة فتضعف، ولا ضيقة فتثقل. وبالرغم من أن النبي داود كان ملكا على بني إسرائيل ولديه وصول كامل لخزائن الدولة (بيت المال)، إلا أنه كان يرفض أن يأكل من مال الرعية أو من كدح غيره. كان يبيع الدرع الواحد، فينفق ثلث ثمنه على نفسه وأهله، ويتصدق بثلثيه. لم يكن مجرد عامل، بل كان “مبتكرا” طور صناعة عسكرية غيرت موازين القوى في وقته. فجاء تاكيد النبي محمد ﷺ على هذه القيمة بقوله: (ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده). لم يشغله الملك ولا النبوة عن مزاولة مهنة شاقة، مما يعطي درسا في أن العمل جزء لا يتجزأ من الإيمان.
وفي ذات السياق، ورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قوله: «من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق»، وهي عبارة عميقة الدلالة، تشير إلى خطورة حصر الرزق بمصدر واحد، وربط الحياة كلها بوظيفة قد تسلب أو تتقلص بقرار أو أزمة. يعد هذا الحديث المروي عن الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) من الأحاديث المشهورة في تراث مدرسة أهل البيت عليهم السلام، والتي تتناول مفهوم “الاستقلال الاقتصادي” والتشجيع على العمل الحر. فمن آجر نفسه: أي صار “أجيراً” يعمل لدى الغير مقابل أجر ثابت (موظف أو عامل تحت إمرة شخص آخر) وحظر على نفسه الرزق: “حظر” تعني منع أو ضيّق. والمقصود هنا أن الأجير قد حدد رزقه بمبلغ معين (الراتب)، بينما الرزق في التجارة والعمل الحر مفتوح ولا سقف له.
انا لست في صدد القول ان الطموح نحو الوظيفة هو حرام او خطأ مطلق فلا يهدف الحديث إلى تحريم العمل لدى الآخرين، بل يرمي إلى توجيه المواطن نحو عزة النفس وتوسيع الآفاق المالية فالأجير يحصل على مبلغ ثابت مهما بذل من جهد إضافي، بينما صاحب العمل أو التاجر يجني ثمار جهده مباشرة. والعمل لدى الغير قد يتضمن نوعا من التبعية أو ضياع القرار الشخصي، بينما العمل الحر يمنح الإنسان استقلالية في وقته وجهده. يتبادر في الذهن هل العمل كأجير “حرام”؟ بالتأكيد لا. الفقهاء والمفسرون يوضحون أن هذا الحديث يحمل جنبة “الكراهية” أو “الإرشاد للأفضل” وليس التحريم. فالإمام الصادق نفسه سئل في روايات أخرى عمن يؤجر نفسه، فكان يوجه بأن الاستغناء عن الأجر بالتجارة أفضل، لكنه لم يمنع منه خاصة إذا كان وسيلة لتأمين القوت.
في زمن الإمام الصادق عليه السلام، كان المجتمع يتجه نحو التخصص والتبادل التجاري. أراد الإمام من خلال هذه التوجيهات بناء مجتمع إسلامي قوي اقتصاديا لا يعتمد أفراده على “فتات” موائد الأثرياء. اضافة الى تشجيع المبادرة الفردية والابتكار في كسب العيش.
الحديث هو دعوة نبيلة للتحرر الاقتصادي؛ فبدلا من أن تكون أداة في مشروع غيرك، يدعوك الإمام لتكون صاحب مشروعك الخاص، لأن الرزق في “السعي الحر” أوسع وأكثر بركة من الرزق “المحصور” في أجر ثابت.
العمل الحر بوصفه مخرجا اقتصاديا
إن التوجه نحو العمل الحر، والتجارة، والصناعة، والمشاريع الصغيرة لم يعد خيارا ثانويا، بل ضرورة اقتصادية واجتماعية. هذا التوجه يخفف العبء عن الدولة، ويخلق فرص عمل حقيقية، ويحرك السوق، ويعزز الاستقلال المالي للأفراد، ويؤسس لاقتصاد متنوع أقل عرضة للصدمات. غير أن هذا التحول يتطلب بيئة داعمة، من خلال تشريعات تحمي المستثمر الصغير، وتسهّل القروض، وتشجع المنتج المحلي، وتعيد الاعتبار لقيمة العمل والإنتاج.
خاتمة: تغيير العقلية قبل السياسات
خلاصة القول، إن الأزمة الاقتصادية الحالية كشفت محدودية النموذج القائم على الوظيفة والاقتصاد الريعي. والخروج من هذا المأزق يبدأ بتغيير العقلية قبل تغيير السياسات، عقلية تؤمن بأن الرزق أوسع من وظيفة، وأن الكرامة الحقيقية تكمن في العمل والإنتاج، لا في انتظار التعيين.
فبقدر ما نتحرر من وهم الأمان الوظيفي، نقترب خطوة من بناء اقتصاد متوازن، ومجتمع منتج، ودولة قادرة على مواجهة الأزمات بثبات وثقة.
















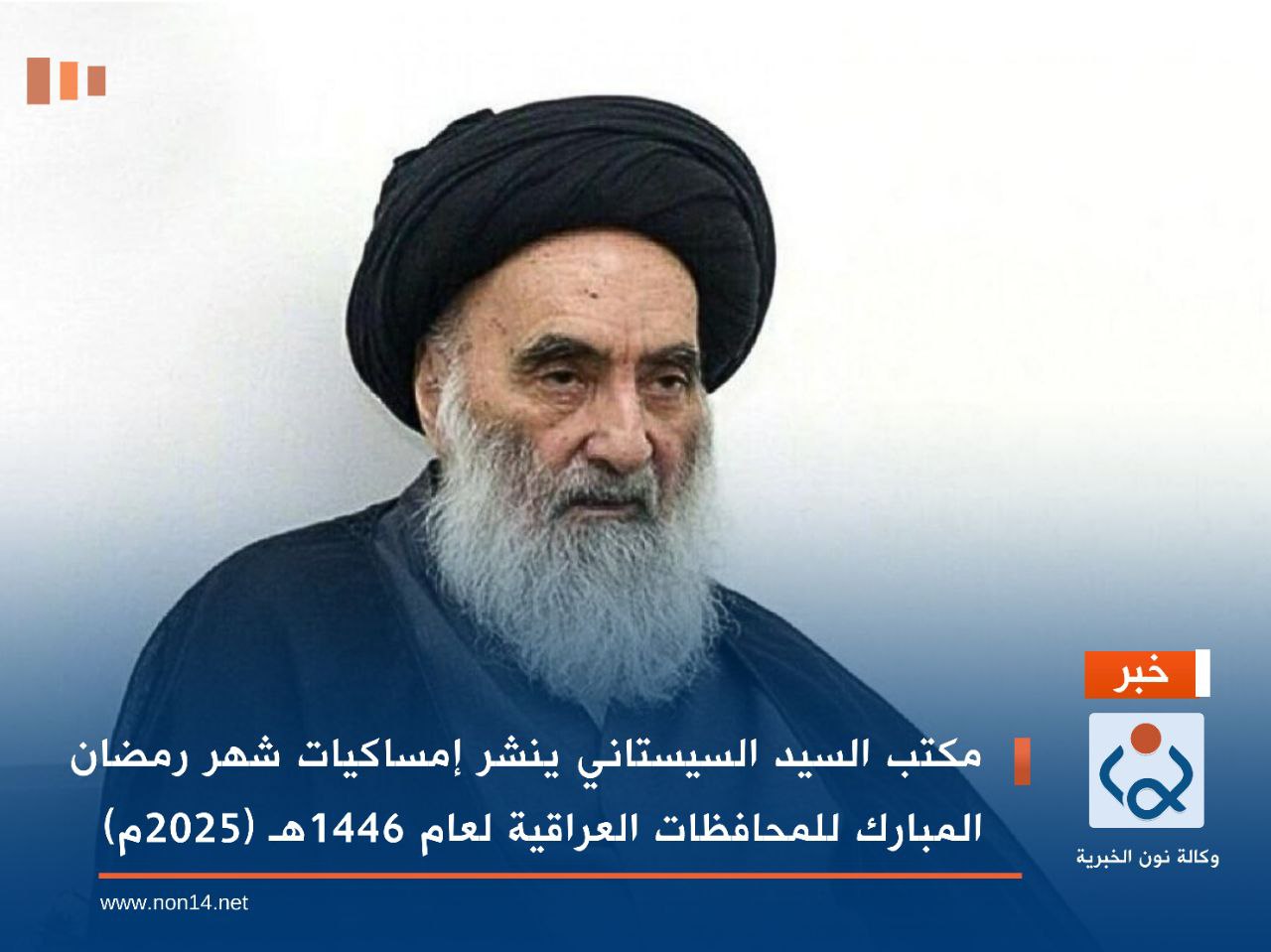




التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!